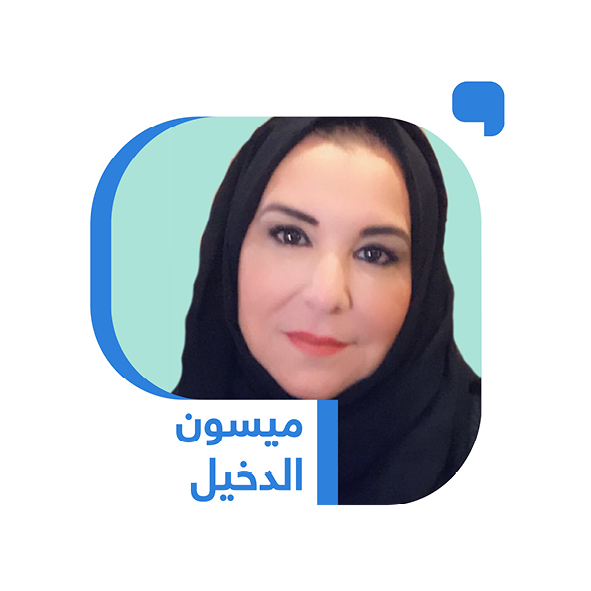مع تقدم الحرب العالمية الثانية، واجهت العديد من المدن الألمانية حملات قصف لا هوادة فيها، ما أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر في الأرواح، وتسبب هذا الدمار في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى دريسدن؛ المدينة التي كان يُنظر إليها أنها أكثر أمانًا نسبيًا مقارنة بالمدن الألمانية الأخرى باعتبارها مركزا للجمال المعماري والثقافة. وبحلول أواخر عام 1944 وأوائل 1945، عندما تعرضت مدن مثل هامبورغ وكولونيا وبرلين لغارات جوية عنيفة، لجأ الآلاف من النازحين إليها.
وكانت نتيجة هذا التدفق ارتفاعًا كبيرًا في عدد سكان دريسدن، ما أدى إلى خلق ظروف مكتظة واستنزاف الموارد. وأثر هذا التحول الديموغرافي بشكل عميق في المدينة قبل الغارات الجوية المدمرة، حيث أصبح العديد من هؤلاء اللاجئين ضحايا للدمار الذي أعقب ذلك؛ ما حدث لاحقًا أنه تحت تيارات نيران الفسفور السائل وأمطار سوداء من الرماد في العاصفة النارية، تحولت مدينة الجمال والثقافة بين عشية وضحاها إلى بومبي ألمانية.
13 فبراير 1945، في واحدة من أكثر الهجمات بالقنابل تدميرًا في التاريخ إلى ما قبل دمار غزة، هاجمت القوات الجوية البريطانية والأمريكية المشتركة مدينة دريسدن على ثلاث موجات، ما خلق عاصفة نارية ذات أبعاد غير عادية، ففي تلك الليلة، أشعل سلاح الجو الملكي النار في المدينة بغارتين استهدفتا مركزها، أحدث نسبة عالية من الدمار، تبعهم الأمريكيون ظهر يوم الرابع عشر.
كانت المدينة تعج بالنشاط، حيث يمارس العديد من السكان حياتهم اليومية غير مدركين للكارثة الوشيكة، وسرعان ما انزلقت المدينة إلى حالة من الفوضى، تحولت الشوارع التي كانت مزدحمة ذات يوم إلى مشهد كابوس مليء بالدمار واليأس، تسببت الحرارة الشديدة الناتجة عن القنابل في ذوبان الأسفلت بالشوارع، تكونت مادة لزجة تشبه القطران، حاصرت الأشخاص الفارين من الحرائق، وكافح الكثيرون من أجل الهروب، لكن أحذيتهم علقت، بينما اشتعلت النيران حولهم، ما خلق أجواء خانقة. وفي ظل يأسهم، لجأ العديد من السكان إلى الأقبية، معتقدين أنهم سيكونون في مأمن من الهجوم الجوي، لكن العاصفة النارية خلقت فراغًا هائلاً أدى إلى اشتعال النيران في هذه الملاجئ، وتحويلها إلى أفخاخ للموت.
أولئك الذين احتشدوا معًا في الظلام، على أمل الحصول على الأمان، وجدوا أنفسهم غارقين في النيران، بينما اندلع الجحيم في الأماكن الضيقة؛ لقد ترك الرعب الناتج عن المحاصرين وعدم القدرة على الهروب من النيران الزاحفة بصمة لا تمحى على الناجين الذين تمكنوا من الفرار. كان الهواء كثيفا بالدخان، وترددت أصداء صرخات الجرحى والمحتضرين في الشوارع، بات الناس مشوشين، يتعثرون في الضباب، يبحثون عن أحبائهم، ليجدوا الدمار عند كل منعطف، ومع اشتعال النيران، امتلأت الشوارع بالجثث، بعضها متفحم لدرجة يصعب التعرف عليها.
الشوارع التي كانت تنبض بالضحك والأحاديث أصبحت الآن مليئة بالحطام والجثث، والهواء مليء بالرائحة الكريهة الناجمة عن المواد المحترقة والمعاناة الإنسانية؛ لقد طغى صمت رهيب على الثقافة النابضة بالحياة التي ميزت مدينة دريسدن، ولم يتخللها سوى الأصوات البعيدة للمباني المنهارة وصرخات الناجين المنكوبة، هكذا أظهر تدمير مدينة دريسدن ومؤخرًا قطاع غزة ما يستطيع الإنسان فعله عندما ينحرف عن طريق العقل ويُفعل قوى الكراهية.
هل طرحت فكرة نقل الناجين من الدمار إلى بلد آخر من أجل إعادة الإعمار؟ لقد كان للعديد من سكان دريسدن روابط عاطفية وثقافية قوية بمدينتهم. وإن طرح مثل هكذا حل يصعب تحقيقه لأسباب عدة منها أن مغادرة منازلهم، حتى بعد تدميرها، سيكون خيارًا مؤلمًا، كانت لديهم رغبة في إعادة بناء مجتمعهم واستعادته تفوق جاذبية البدء من جديد في أرض أجنبية، فلقد كان هناك شعور قوي بالانتماء للمجتمع بين الناجين، حيث أراد الكثيرون البقاء وإعادة بناء مدينتهم معًا، ولعبت هذه الروح الجماعية دورًا حاسمًا في التعافي، حيث سمح التركيز على إعادة البناء داخل مدينتهم للسكان باستعادة هويتهم وتراثهم وسط الدمار، واليوم عادت منارة كما كانت يومًا.
كما أعاد شعب مدينة دريسدن بناءها، يستطيع سكان غزة أيضًا أن يجدوا الأمل والتصميم في مواجهة الدمار، إن الروابط العاطفية مع أرضهم مع وطنهم، جنبًا إلى جنب مع الجهد الجماعي لاستعادة مجتمعهم، تعد محفزات قوية يمكن أن تؤدي إلى التمكن من إعادة بنائه، فإن خيار البقاء وإعادة البناء يجب أن يقع على عاتق أصحاب الأرض وسكانها الأصليين، مع احترام حقوقهم وتطلعاتهم للمستقبل، وفي نهاية المطاف يجب ألا ننسى أن مصادر القنابل التي دمرت دريسدن هي نفسها التي مولت تدمير غزة، المأساة نفسها، الوحشية نفسها، الحرق نفسه، لماذا إذن عند تقرير المصير يختلف الأمر وتنقلب المعايير والحقوق؟!